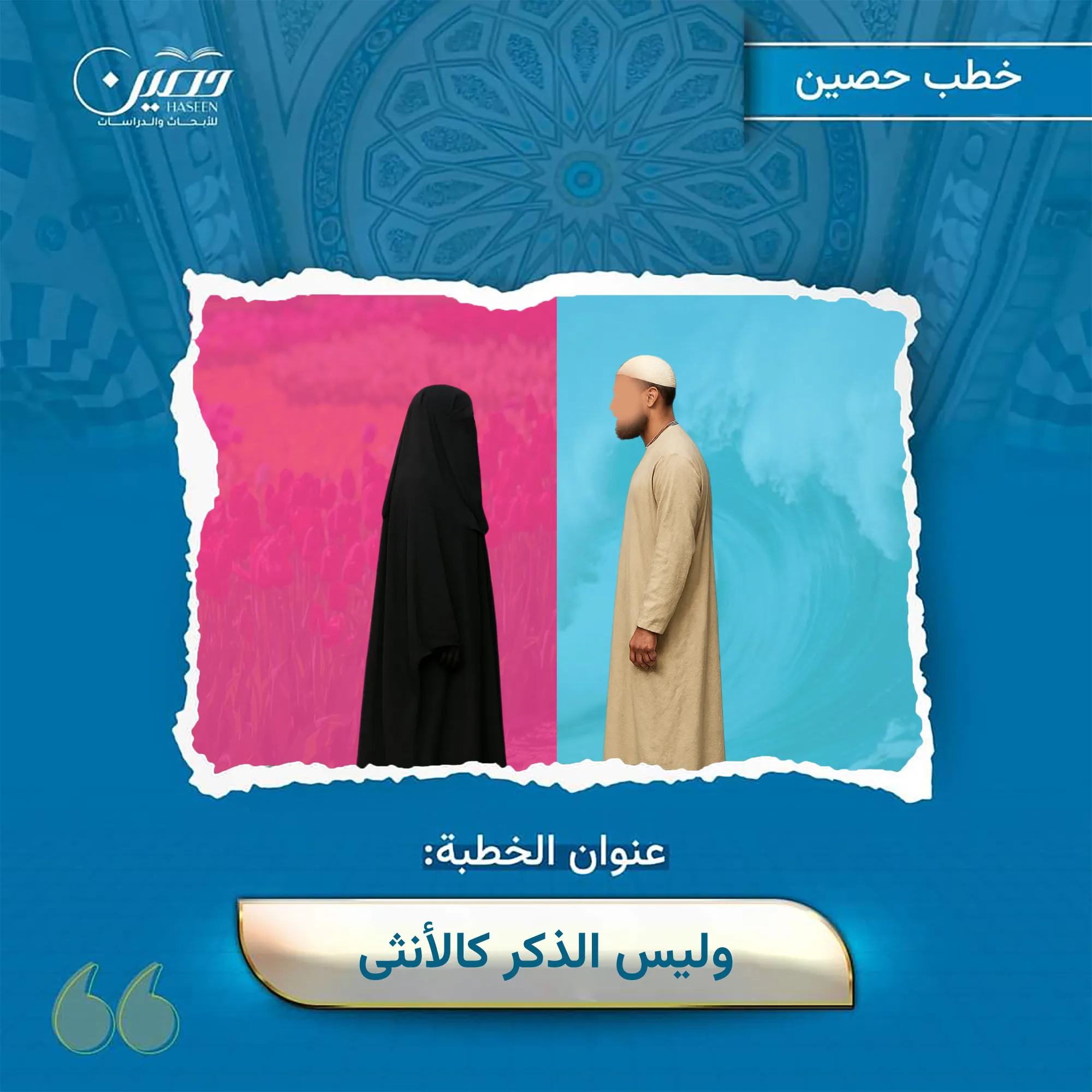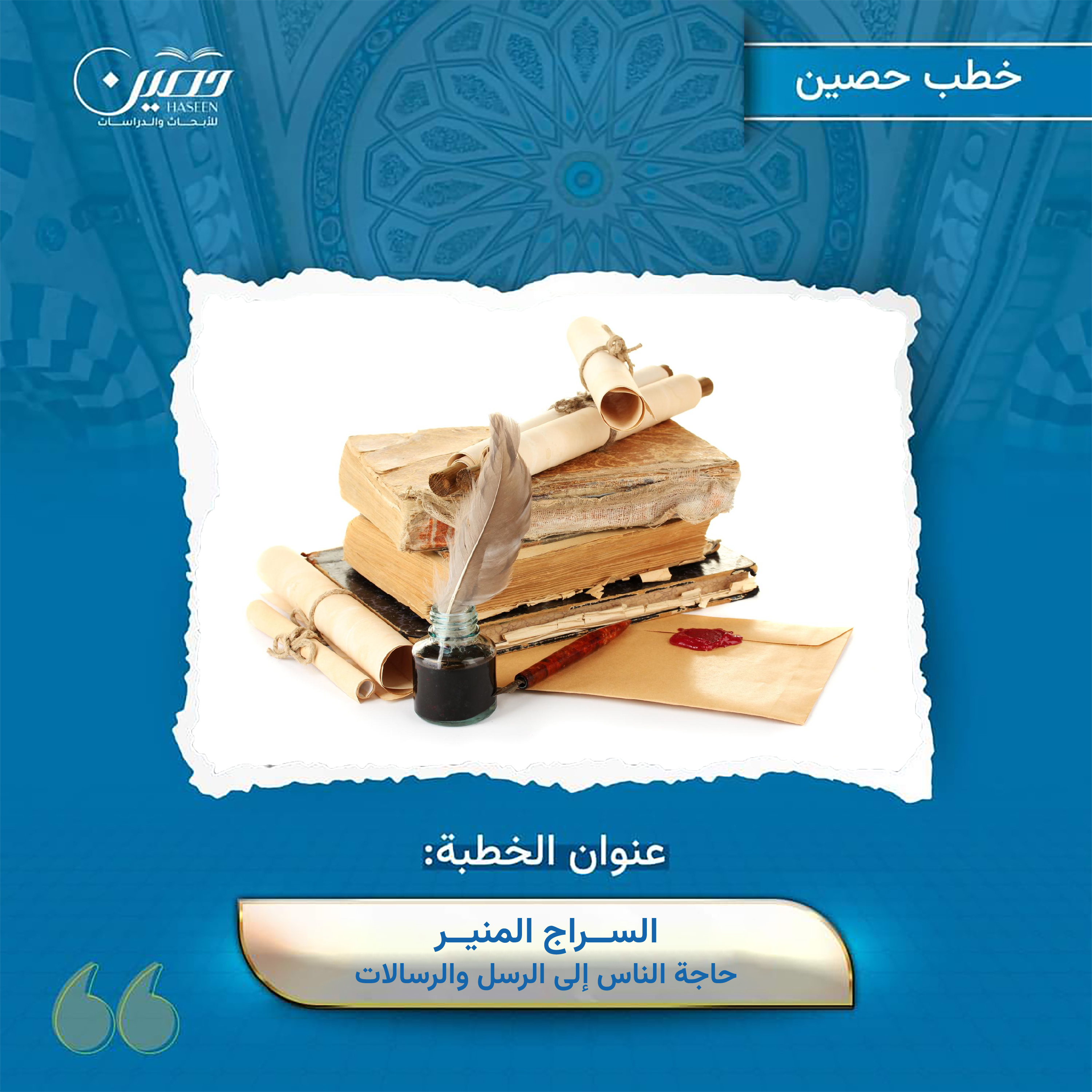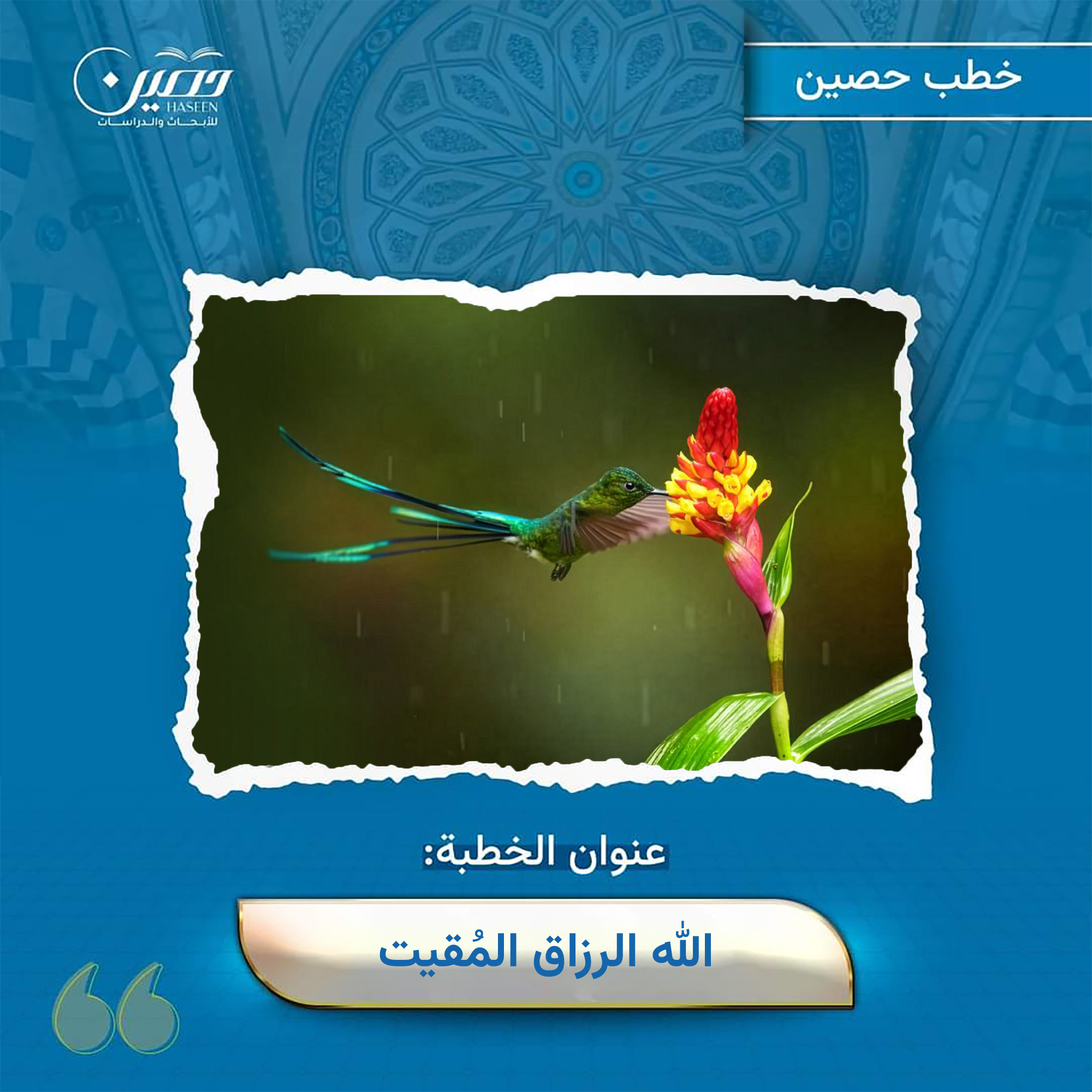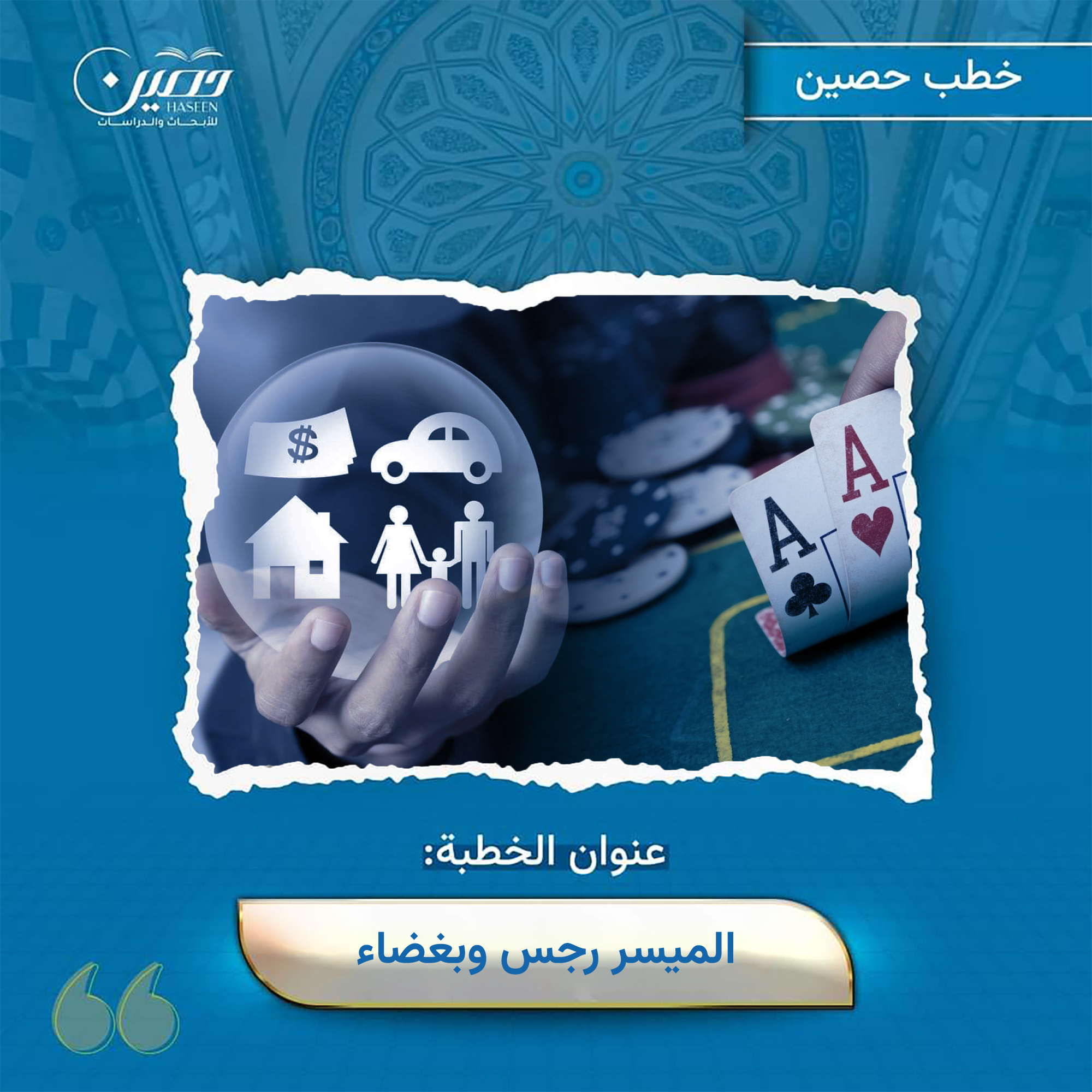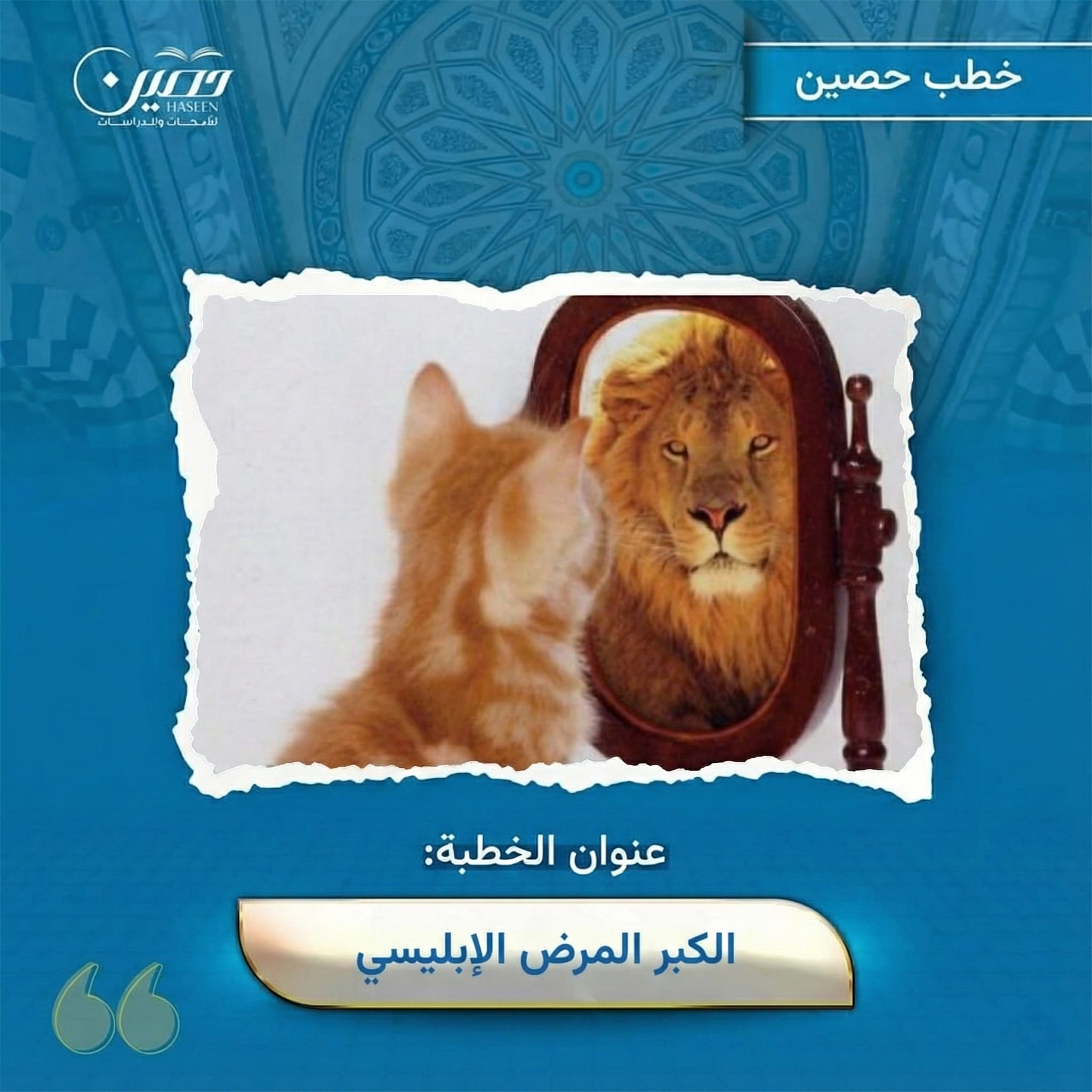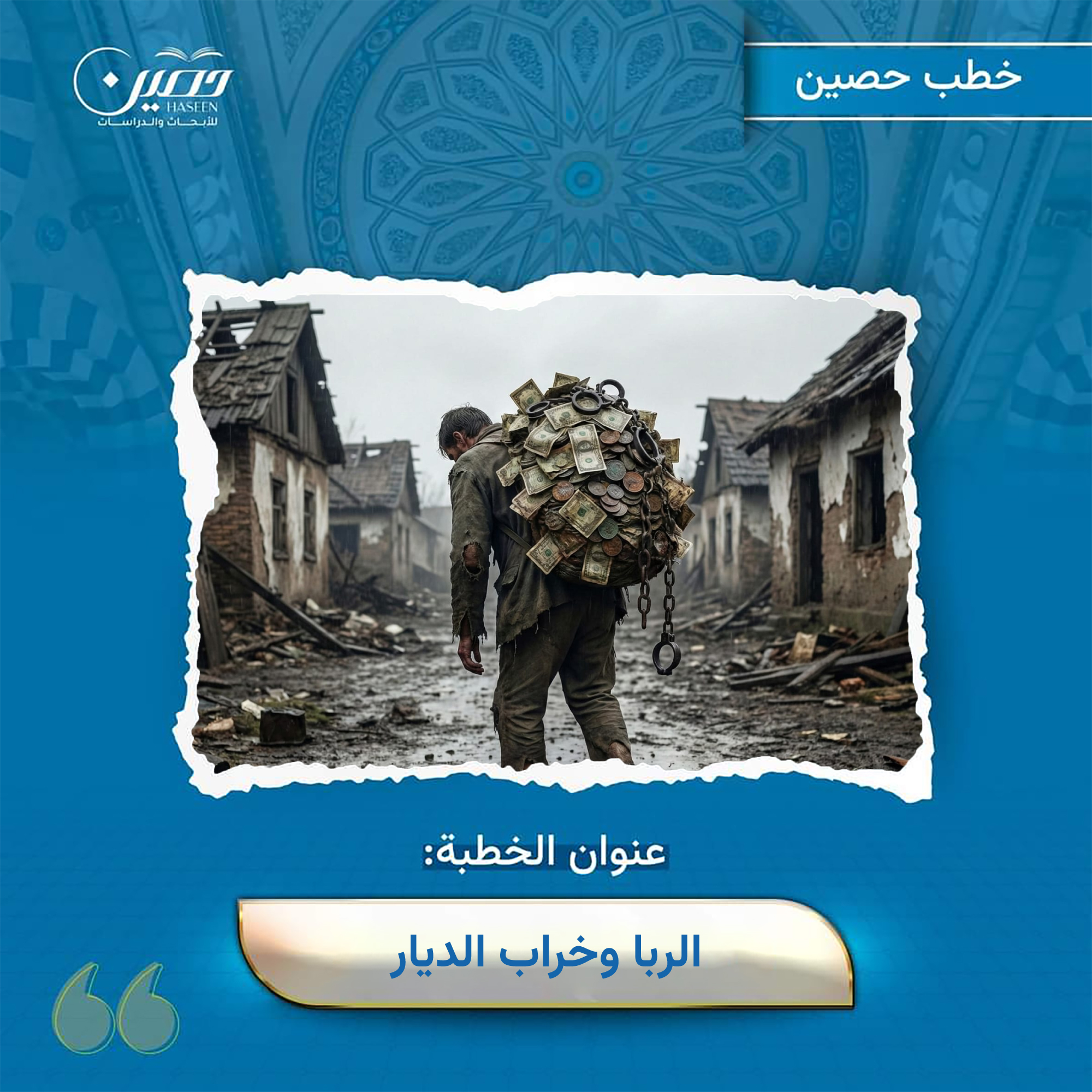عنوان الخطبة
﴿وَلَيسَ الذَّكَرُ كَالأُنثى﴾.
عناصر الخطبة
١- الرَّجُل والمرأةُ سِيّانِ في أصلِ التكليف.
٢- للرِّجال على النّساء فضلٌ ودرجة.
٣- خصَّ اللهُ المرأةَ بأحكامٍ وحُقوق.
٤- العلاقةُ بين الرجل والمرأة تكامُلٌ وموالاة.
الحمدُ للهِ الذي أنزلَ الكتابَ ولم يجعلْ لهُ عِوجًا، وتمَّت كلماتُهُ صِدقًا وعدلًا، وأشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.
أمّا بعدُ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التَّقوى، وراقبوهُ في السِّرِّ والنَّجوى، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
عبادَ الله:
في ذاتِ يوم أتت أُمُّ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيَّةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: «مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ لِلرِّجَالِ، وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ؟» فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: ٣٥]جامع الترمذي (٣٢١١)، من حديث أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٦٥) (١).
لقد كانَ جيلُ الصَّحابةِ من الرِّجالِ والنساءِ جيلًا فريدًا، فهذهِ أُمُّ عُمارةَ كانت تسمعُ القرآنَ يُتلى فترى الخطابَ في أغلبِهِ للذُّكورِ، وتدخلُ الإناثُ فيهِ تبعًا، لكنَّها أحبَّت أنْ ترى ذكرَ النِّساءِ في فضلِ الإسلامِ والإيمانِ، فأنزلَ اللهُ الآياتِ البيِّناتِ.
إنَّ اللهَ ربُّ العالمينَ جميعًا؛ رجالِهِم ونسائِهِم، أنزلَ كُتبَهُ وأرسلَ رُسلَهُ لبني آدمَ، ليُخرجَهم مِنَ الظُّلماتِ إلى النُّورِ، وجعلَ سبحانَهُ التَّقوى مَيْدانَ المسابقةِ، فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير [الحجرات: ١٣].
أمَرَ سبحانهُ الرِّجالَ والنِّساءَ بالإيمانِ والعَمَلِ الصّالحِ، فهُم سواءٌ في أصلِ التَّكليفِ، وهُم سواءٌ في الثَّوابِ والعقابِ عندَ اللهِ.
قال سبحانه: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا [النساء: ١٢٤].
وقال سبحانه: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ٢].
لقد أصَّلَ النبيُّ ﷺ أصلًا عظيمًا حينَ قال: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». جامع الترمذي (١١٣)، من حديث عائشة رضي الله عنهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٨٦٣). (٢)، وذلكَ يعني أنَّ الأصلَ تساوي أحكامِ الشَّريعةِ بينَهما، ما لم يدلَّ الدَّليلُ على الاستثناءِ والتَّخصيصِ، فكلُّ أمرٍ أو نهيٍ في دينِ اللهِ هو عامٌّ يشمَلُ الرِّجالَ والنِّساءَ، وكلُّ فضلٍ أو عقوبةٍ يعمُّ الفاعلَ رجلًا كانَ أو أنثى.
إلَّا أنَّ الرَّبَّ العليمَ الحكيمَ، الذي تمَّت كلماتُهُ ودينُهُ صِدقًا وعَدلًا لم يساوِ مساواةً مطلقةً بينَ الرِّجالِ والنساءِ، وإنَّما خصَّ الرِّجالَ ببعضِ الأحكامِ دونَ النِّساءِ، وكذلكَ خصَّ النِّساءَ ببعضِ الأحكامِ دونَ الرِّجالِ.
وعندما خفَتَت شمسُ الشَّريعةِ، طغَت غُيومُ الضَّلالةِ، فقامَ أبواقُها يُنادونَ على النّاسِ بما يُصادِمُ الفطرةَ والدِّينَ مُطالِبينَ بالمساواةِ المطلقةِ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ، ثُمَّ قامَ على إثْرِهمُ المُزوِّرونَ لينسُبوا ذلكَ إلى دينِ اللهِ، فهل هذا حقٌّ أم باطلٌ؟
إنَّ بينَ المساواةِ والعدلِ فَرقًا عظيمًا، فالعدلُ الذي قامت بهِ السَّماواتُ والأرضُ هو إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ، ووضعُ الشَّيءِ في موضعِهِ، وأمَّا المساواةُ فهي المماثلةُ بينَ الشَّيئينِ، وقد اتَّفقَ العُقلاءُ على أنَّ المساواةَ إنَّما تكونُ عدلًا إذا تماثلَ الطَّرَفانِ من كلِّ وجهٍ، فأما إذا اختلفا فالمساواةُ حينئذٍ ظُلم، فلو كانَ لديكَ وَلَدانِ، أحدُهما كبيرٌ والآخرُ صغيرٌ، أو أحدُهما صحيحٌ والآخرُ مريضٌ، فهلِ المساواةُ بينَهما في النَّفقةِ والطَّعامِ تُعَدُّ عدلًا؟
لقد قالَ اللهُ في كتابِهِ آيةً محكمةً: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى [آل عمران: ٣٦].
إنَّ المرأةَ تختلفُ عنَ الرَّجلِ في الخصائصِ الجِسميَّةِ والبدنيَّةِ والنَّفسيَّةِ اختلافًا لا يُنكِرُهُ عاقلٌ، ولذا قالَ سبحانهُ مشيرًا إلى طبيعةِ المرأةِ: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف: ١٨].
إنَّ جِنسَ الرِّجالِ أفضلُ في الجُملة والأصلِ من جِنسِ النساءِ، فهُم أكملُ عقلًا وأرشدُ رأيًا وأقوى بَدَنًا، ولذا جعلَ اللهُ النُّبوَّةَ في الرِّجالِ، وجعلَ شهادةَ المرأةِ على النِّصفِ من شهادةِ الرَّجلِ، فقال سبحانه: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [البقرة: ٢٨٢].
وقرَّرَ النَّبيُّ ﷺ الوِلايةَ العامَّةَ للرِّجالِ دونَ النساءِ فقال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»صحيح البخاري (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. (٣).
وجعلَ اللهُ تعالى للرَّجُلِ القِوامةَ على المرأةِ، وهيَ تشريفٌ وتكليفٌ، شرَّفَ اللهُ الرَّجُلَ بما أهَّلَهُ في أصلِ خِلقَتِهِ؛ ليقومَ على المرأةِ سُلطةً وصيانةً وإنفاقًا ورعايةً.
قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[النساء: ٣٤].
لقد جعلَ اللهُ للزَّوجِ على زوجتِهِ حقوقًا، وجعلَ للزَّوجةِ على زوجِها حقوقًا، ومعَ ذلكَ رفعَ الزَّوجَ على زوجتِهِ درجةً، فقال سبحانه:وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ٢٢٨].
عبادَ الله:
إنَّ مَن قرأَ كتابَ اللهِ وسنَّةَ نبيِّهِ ﷺ يرى يقينًا أنَّهُ رُغمَ أنَّ الأصلَ استواءُ الرَّجلِ والمرأةِ في أصلِ التكليفِ، فإنَّ للمرأةِ أحكامًا تفترِقُ بها عن الرَّجلِ، مُراعاةً لأصلِ خِلقَتِها وما جبلها عليهِ؛ عدلًا منهُ سبحانهُ ورحمةً، لأنَّهُ يقولُ جل وعلا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦].
لقد أسقطَ الإسلامُ عنِ المرأةِ أداءَ الصَّلاةِ والصِّيامِ حالَ الحَيْضِ والنِّفاسِ، وأوجبَ عليها بعدَ الطُّهرِ قضاءَ الصَّومِ دونَ الصلاةِ، ولم يُوجبْ عليها الجُمُعةَ والجماعةَ، ولا الجهادَ والغزوَ، فهذه عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «جِهَادُكُنَّ الحَجُّ» صحيح البخاري (٢٨٧٥)، من حديث عائشة رضي الله عنه. (٤).
وأوجبَ على الرَّجلِ النَّفقةَ على أهلِهِ وولدِهِ بالمعروفِ، ولم يُوجبْ ذلكَ على المرأةِ، فقال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٣٣].
وخصَّها الشَّرعُ بأحكامٍ دونَ الرَّجُل، فأباحَ لها ما لم يُبِحْهُ للرَّجُل، وحرّمَ عليها أشياءَ أحلَّها للرَّجُل.
ثبتَ أنَّ النبيَّ ﷺ أخذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»سنن ابن ماجه (٣٥٩٥)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٨٩٦). (٥).
وحرَّمَ على المرأةِ السَّفرَ بلا مَحرَمٍ، ونهاها عنِ الخروجِ متبرِّجةً ومتعطِّرةً، وحرَّمَ عليها أنْ تنكحَ غيرَ المسلمِ.
وإنَّ للمرأةِ في الإسلامِ حقوقًا كما للرجلِ حقوقٌ، إلَّا أنَّ هذهِ الحقوقَ شرعَها اللهُ بما يُوائمُ فطرةَ كلِّ واحدٍ ومسؤوليَّته.
ففي الميراثِ فرضَ اللهُ لهنَّ نصيبًا مثلَ الرِّجالِ، فقال: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء: ٧].
إلَّا أنَّهُ جعلَ للذَّكرِ مثلَ حظِّ الأنثيَينَ فقال:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: ١١].
وهذا يُوائمُ ما كُلِّفَ بهِ الرَّجلُ من وجوبِ المَهرِ والنَّفقةِ؛ لأنَّ الربَّ عدلٌ حكيمٌ.
وجعلَ سبحانهُ تولِّي عقدَ النِّكاحِ والطَّلاقِ والرَّجعةِ بيَدِ الرَّجلِ؛ لرُجْحانِ عقلِهِ وبُعدِهِ عنِ العاطفةِ، إلَّا أنَّهُ في ذاتِ الوقتِ جعلَ حضانةَ الصِّغارِ عندَ الطَّلاقِ للأمِّ؛ لرُجحانِ رحمتِها وشَفقتِها، فقد جاءت امرأةٌ يومًا رسولَ اللهِ ﷺ فقالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». سنن أبي داود (٢٢٧٨)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٦٨) (٦).
وحتَّى في الحقوقِ الزَّوجيَّةِ، لكلٍّ منهما حقٌّ يُناسِبُ ما أُنيطَ بهِ، فمن حقوقِ الرَّجلِ الطّاعةُ، ومن حقوقِ المرأةِ النَّفقةُ والعِشرةُ بالمعروفِ.
ها هو النبيُّ ﷺ يقولُ في خُطبةِ الوداعِ بينَ أصحابِهِ: «أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» جامع الترمذي (١١٦٣)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (٢٠٣٠). (٧).
وقال النبيُّ ﷺ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» مسند أحمد (١٦٦١)، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحسنه الألباني في آداب الزفاف (ص ٢٨٦). (٨).
باركَ اللهُ لي ولكُم في القرآنِ العظيمِ، ونَفَعني وإيّاكم بما فيهِ من الآياتِ والذِّكرِ الحكيمِ، وأَستغفرُ اللهَ لي ولكُم فاستغفِروهُ، إنَّه هو الغَفورُ الرّحيمُ.
الخطبة الثانية
الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسُولِ الله، وعلى آلِهِ وصَحبِهِ ومَن والاهُ، وبعدُ:
فقد كانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ كالمتاعِ، تُورَثُ ولا تَرِثُ، حتى قالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ: «وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ» صحيح البخاري (٤٩٣١)، وصحيح مسلم (١٤٧٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٩).
إنَّ اللهَ بعدلِهِ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، والمؤمنُ يُسلِّمُ لحُكمِ اللهِ، ولا يجدُ ضِيقًا وحرجًا.
قال سبحانه: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [النساء: ٣٢].
إنَّ الرُّجولةَ وصفٌ يُمدَحُ بهِ الرَّجلُ وتُذمُّ بهِ المرأةُ، والأنوثةَ وصفٌ تُمدَحُ بهِ المرأةُ ويَقبُحُ وصفُ الرَّجُلِ بهِ، فإذا خرجَ أحدُهما عنْ فطرتِهِ استحقَّ غضبَ اللهِ ولعنَتَهُ.
يقول عبدُ الله بنُ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»صحيح البخاري (٥٨٨٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (١٠).
إنَّ العلاقةَ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ علاقةُ تكامُلٍ لا تنافُرٍ، وعلاقة موالاةٍ لا بُغضٍ ومعاداةٍ، فكِلاهُما مأمورٌ بالعبوديَّةِ للهِ وإقامةِ دينِهِ وَفقَ ما كلَّفَهُ اللهُ بهِ حيثُ قالَ: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة: ٧١].
اللهمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمينَ، وأهلِكِ الكفَرةَ المجرمين، اللهمَّ وأنزلِ السَّكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في سبيلِكَ، ونجِّ عبادَكَ المستضعَفينَ، وارفعْ رايةَ الدِّينِ، بقُوَّتِكَ يا قويُّ يا متينُ.
اللّهُمَّ آمِنَّا في أوطانِنا، وأصلِحْ أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورِنا، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتّقاكَ واتّبعَ رِضاك.
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.