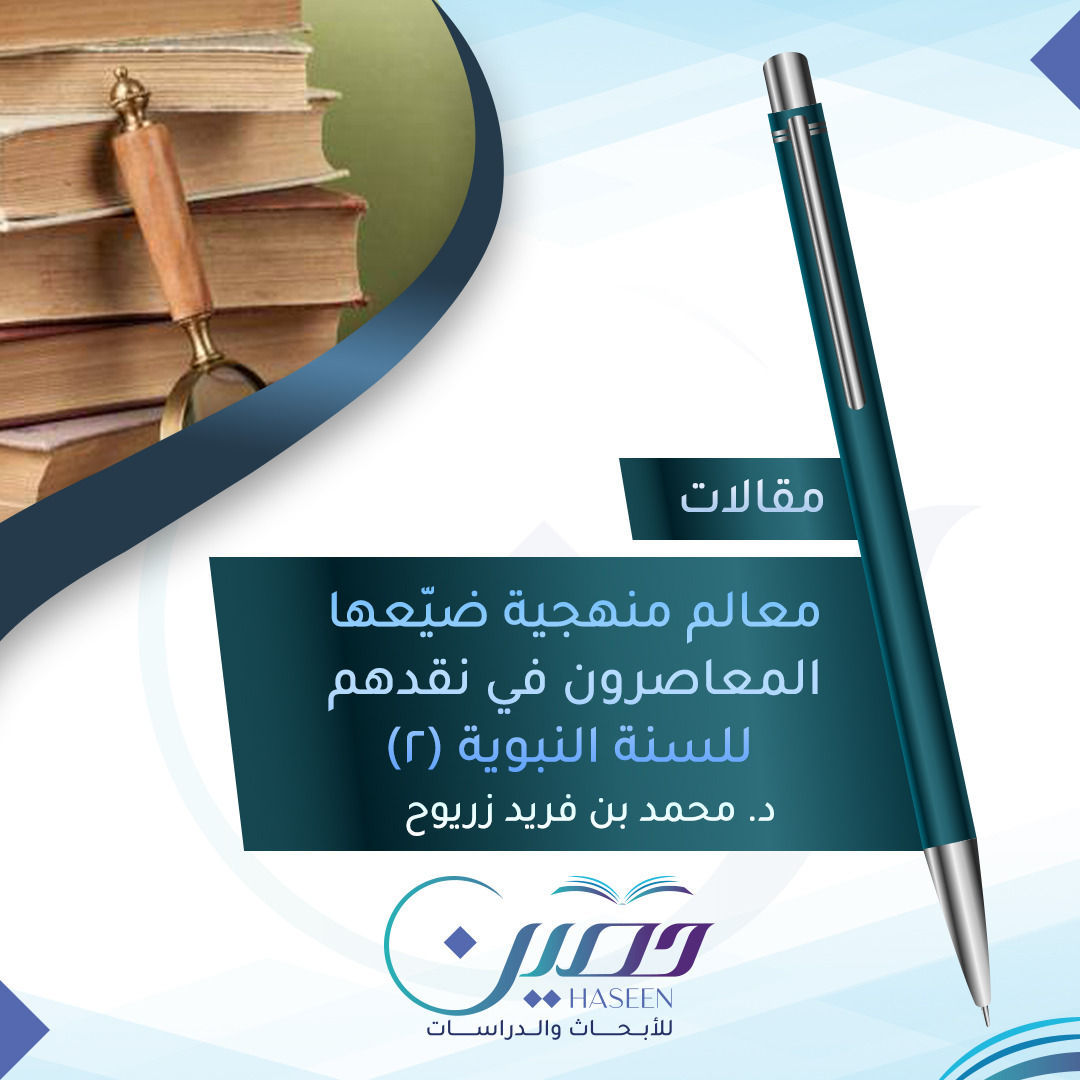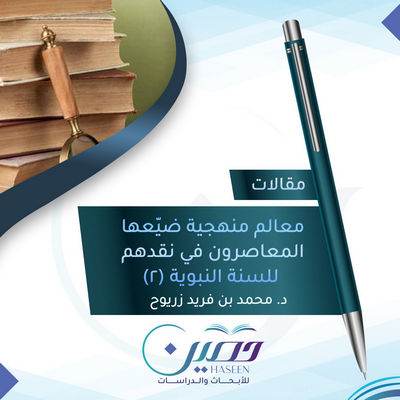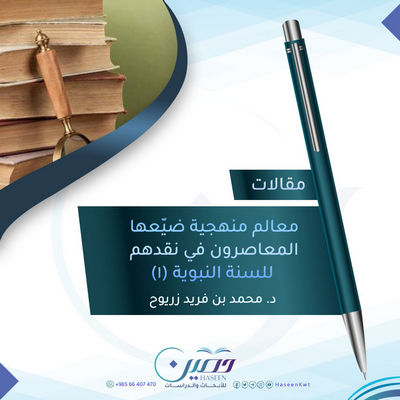بسم الله الرحمن الرحيم
النَّاسُ في رَدِّ الأخبار الشَّرعيَّةِ درجاتٌ، تَتفاوت رُتَبُهم في مُفارَقتها بقدرِ ما داخلَ نفوسَهم مِن العوارضِ والعوائقِ الفكريَّةِ الفاسدةِ، فكثيرًا ما تكون الدَّعاوي العقليَّة المُنطلَقَ لأيِّ انحرافٍ عن السُّنة.
ونتيجةً لذلك: يجدُ أحدُنا في مَقالاتِ المُناوئين لأهل السُّنة في موقفهم مِن النُّصوصِ الشَّرعيَّة ـ بدءًا من المدارسِ الكلاميَّة والفلسفيَّة القديمةِ، وانتهاءً بتفرُّعاتِهم الفكريَّة المُعاصرة ـ يجدُ ارتكازَهم في تأسيسِ مَذاهبِهم قائمًا على «أوَّليةِ العقلِ على النَّقلِ»؛ الأصلِ الجامع الَّذي يَنتظم نظرَتَهم إلى الأخبار النَّبويَّة، وأمِّ شُبهاتِهم في باب التَّعارضِ بين الأدلَّة.
وكلَّما عَظُمَ هذا الأصل في نفوس النَّاس ضَعُف تسليمها لنصوصِ الوحي، حتَّى صار هذا الأصل فصلَ ما بين أهل السُّنة وبين المُبتدعةِ ـ كما قال السَّمعاني (ت٤٨٩هـ) ـ فإنَّهم أسَّسوا دينَهم على المَعقولِ، وجَعلوا الاتِّباعَ والمأثورَ تَبعًا للمَعقول «الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة الأصبهاني (١/٣٤ (١).
ذلك أنَّ حُجيَّة الخبرِ عندهم لا يُمكن بحالٍ أن تُعلم إلاَّ بإثباتِ الدَّلالة العقليَّة لها، فإنَّ تقديمَ النَّقل في هذه الحال مستلزمٌ القدحَ في أَصلِه، فضلًا عن كونِ العقل قطعيَّ الدَّلالة، بخلاف النَّقل فهو ظنيٌّ في ثبوته أو دلالته، والقطعيُّ مُقدَّم أبدًا على الظَّنِّي على هذا الأساس ابتنى الفخر الرازي (قانونه الكلِّي)، حيث جعل الغلبة والتقديم للدلالة العقلية عند حصول مناقضة بينها وبين ظواهر الشَّرع، وأقصى به ظاهر النصوص بنفي كونها مرادا للشارع، أو بالطعن في صدق نسبتها إليه. انظر كتابه أساس التقديس (ص/١٣٠). (٢).
هذا عينُ ما توسَّل به المُخالفون لرَدِّ جُمَلٍ مِن صِحاحِ الأخبار، بدءًا بالمعتزلة ثمَّ انتهاءً بالعَلمانيَّين، وإلزامهم بالقدح في العقل إذا ما قُدِّم عليه النَّقل عند التَّعارض ـ إذ كان أصله ـ هو دعوى لا تحقُّق لها في سوقِ الدَّلائل الشَّرعيَّة، بل هو توهُّمٌ ناشئٌ عن افتعالِ الخصومةِ بين العقلِ والنَّقل، ولا خصومةَ بينهما عند التَّحقيق.
وجه ذلك: أنَّ النَّقلَ الثَّابتَ عند علماء المِلَّة لا يكون مُنافيًا للعقل الفطريِّ؛ بحيث تكون دلالتُه مُنافيةً لمبدأ عدم التَّناقضِ ـ مثلاً ـ؛ إنَّما تَتحقَّق المنافاة بين (نَقْلٍ مَنحولٍ) و(عقلٍ صَريح)، أو بين (عَقْلٍ مَدخولٍ) و(نقلٍ صحيح)؛ فلَكَم اضطرب أدعياء العقل في معقولاتهم اضطرابًا غير يسير.
تجد من يقول: إنَّا نعلمُ بالضَّرورةِ أمرًا، والآخرون يقولون: نعلمُ بالنَّظرِ أو بالضَّرورةِ ما يُناقِضُه! ثمَّ مَن جَمَع منهم بين هذه الحُجَج أدَّاه الأمرُ إلى تكافؤِ الأدلَّة، فيبقى في الحيرةِ والوقفِ أو إلى التَّناقض! «الصَّفدية» لابن تيميَّة (١/٢٩٤-٢٩٥). (٣).
فلا عجب أن يكون نفس العقل المَقول بأوَّليَّتِه غيرُ مُنضبِطِ المَعالِم لدى أَصحابِه، إذْ كلُّ طائفةٍ أَصَّلَت لها أُصولًا مذهبيَّة تَتَمعْقلُ بها على الأخبار النَّبويَّة؛ ما وافقها قُبِلَ، وما خالفها رُدَّ.
إنَّ النَّظر العَقليَّ ليس مِيزانًا دَقيقًا رِياضيًّا لا يختلِفُ النَّاس في أحكامِه حتَّى تُدَّعى قطعيَّته باطِّراد، لاحتمالِ ورود قوادح على الواسطةِ بين المُقدِّماتِ ونتائجِها أثناء عمليَّة التَّفكير، فيكون مَنْبعُ الزَّللِ مِن جهةِ تحقيقِ مَناطِ المُقدِّمة المُتيقَّنة على نتائجها، فضلًا عن أن يتلبَّس الحوَاسَّ أوهامٌ تتشكَّل بها صورةٌ مغلوطةٌ في العقل عن الواقع.
ثمَّ إنَّ النَّاس بطبيعتهم تأثُّرهم غير محصور في المنطقِ العِلميِّ الصَّارِم فحسب؛ عقلُ الإنسانِ لا يعمل بهذه الطَّريقة الآليَّةِ البحتَة، بل أكثر العقولِ تَتأثَّر بخبرةِ الإنسان، أو عاطِفَتِه، أو هَواه، أو بيئتِه، ويَعتري نفسَ العقلِ الذُّهولُ والغفلة، وتُؤثِّر فيه الضُّغوط والمُتغيِّرات، وعوامِلُ كثيرةٌ تَتدخَّل في طريقةِ تفكيرِه، شَعَر أصحابه بذاك أم لا؛ ما يجعلُ الإنسانَ يُغيِّر رأيَه في كثيرٍ مِن القَضايا، بعد أن كان يَرى رأيَه الأوَّل فيها عَينَ العقلِ.
و«إذا أرادَ الله أن يُزيلَ عن عبدٍ نِعمةً، كان أوَّلَ ما يُغِيِّر منه عَقلَه» نَقَله الجاحظ في «البيان والتبيُّن» (٢/١٩٩) من قولِ فيروز بن حُصين. (٤)!
ومِن ثمَّ نقول: إنَّ السَّيرَ في إنكار المرويَّات الحديثيَّة بخُطًى واسعةٍ بناءً على ما تُمليه عقول النَّاس على اختلافها «يودي إلى فوضى لا يعلَمُ مُنتهاها إلَّا الله، وإلى أن تكون السُنَّةُ الصَّحيحة غيرَ مُستقرَّةِ البُنيان ولا ثابتة الدَّعائم؛ ففُلانٌ يَنفي هذا الحديث! وفلانٌ يُثبته! وفلانٌ يتوقَّف فيه! كلُّ ذلك لأنَّ عقولهم كانت مُختلفةً في الحُكمِ والرَّأي والثَّقافة والعُمق.. فكيف يجوز هذا؟!» «السُّنة ومكانتها في التَّشريع الإسلامي» لمصطفى السِّباعي (ص/٢٧٩). (٥).
لا يكون الارتكازُ على هذا المَسلكِ أو التَّوسُّع فيه إلَّا غلَطًا محضًا وعُدولًا عن السَّنَن الأبينِ الَّذي سار عليه جهابذة الإسلام.
والواقع شاهد: بأنَّ اتِّفاقَ أَهلِ الحديثِ على صِحَّةِ خبَرٍ مُحْكَمٌ لم ينخرم، إذْ لم نَرَ لهم نِزَاعًا فيه بعد اتِّفاق، والعِصمة المُحصَّلة مِن اتِّفاقِهم هذا أقوَى مِمَّا يُظَنُّ أنَّه يقينٌ عقليٌّ؛ فكان اتّباع أحكامِ هؤلاء المُختصِّين في نقد الأَخبارِ هو القَدْر المتحتِّم لزومُه على منَ ليس مِن أَهل هذه الصَّنعة الشَّريفة انظر «دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث الاعتقاد» لعيسى النعمي (ص/٦١-٦٣). (٦).
إذا تقرَّر هذا: فلا مناص من القول بأنَّ كِلَا الدَّليلين ـ العقليّ والنَّقليّ ـ تَعْتوِرُهما القطعيَّةُ والظَّنيَّةُ، فلا تُحصَر القطعيَّة في الدَّليل العقليِّ، ولا الظَّنية في الدَّليل النَّقلي؛ بل لا يخلو الحالُ مِن أنْ يكون الدَّليلان: إمَّا قطعيَّين، أو ظنِّيَّين، أَو يكون أحدهما قطعيًّا، والآخر ظَنيًّا.
فإن كانا قَطعيَّين: فإنَّه يمتنع حصولُ التَّعارض بينهما، لاستلزام الجمع بين النَّقيضين، وهو غير جائز «البحر المحيط» للزركشي (٨/١٢٤). (٧).
وإن كانا ظَنِّيَين: اُلْتُمِسَ ترجيحُ أحَدِ الدَّليلين بمُختلف الأدوات الأصوليَّة المُمكنة، فأيُّهما تَرجَّح بها كان هو المُقدَّم.
وأمَّا في حالةِ كونِ أحَدِهما قَطعِيًّا والآخر ظنِّيًا: فإنَّ التَّقديمَ حاصلٌ للقَطعيِّ منهما، سواء كان سَمعيًّا أو عقلِيًّا انظر «درء التعارض» لابن تيمية (١/٧٩-٨٠)، وهو أجلُّ من أبان عن هذا التَّفصيل، وأسهب في كشف شبهة الرَّازي في قانونه الكلِّي. (٨).
وبهذا التَّقرير ينجلي ما تأسَّست عليه دعوى (أوليَّة العقل) مِن مُغالطة ناشئة عن نظرِ أصحابها إلى نوعِ الدَّليل، لا إلى مَرتبتِه في درجاتِ التَّصديق.
والصَّواب ـ كما قرَّرناه ـ أن يتَّجه النَّظر إلى درجة الدَّليل، فيُقال:
إن كان النَّظر العقليُّ (قطعيًّا): قُدِّم على الحديث (الظَّنيِّ) عند التَّعارض.
وإن كان النَّظر (ظنِّيًا): لم يُقدَّم على الحديث (الظنِّي)، إلَّا إن كان (أقوى منه) بمرجِّحات معتبرة.
وأمَّا إن كان الحديث (قطعيًّا): فمُقدَّمٌ هو ـ لا شكَّ ـ على هذا النَّظر العقليِّ.
على أنه يجب التنبّه إلى أنّ القطعيّة في السنة النبويّة لا تقتصر على المتواتر منها فحسب، بل توجد جملة كبيرة من أحاديث الآحاد القطعيّة في ثبوتها ودلالتها، وذلك راجع إلى قرائن احتفّت بالحديث، كاستفاضته وشهرته وإن لم يبلغ حدّ التواتر، أو اتفاق الشيخين -أعني البخاريّ ومسلمًا- على إخراجه، أو تلقّي الأمّة له بالقبول، أو غير ذلك من القرائن انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٨/٤٨)، و «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (١/ ٣٧٧-٣٧٩). (٩).
قال ابن عبد البر رحمه الله: «وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا؛ إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعدّ خلافا» «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٢). (١٠).
وحاصل القول: أنَّ غَلطَ القائلين بتلك القِسمة الخاطئة لمِا هو قطعيٌّ وظنيٌّ من دلائل العقل والنَّقل، ناجمٌ عن نقصِ تشرُّبٍ لدلائلِ الشَّريعة، فما عادَت تُفيد في قلوبِهم ذاك اليقينَ الَّذي تُفيدُه الدَّلائل العَقليَّة الَّتي أقبلوا عليها؛ مِمَّا أفضى بهم إلى مَزيدِ إعراضٍ عن أخبارِ الآحادِ، ومِن ثَمَّ استسهلوا رَدَّها لأدنى شُبهةِ مُخالفةٍ لتصوُّراتهم.
فالخطرُ كلُّ الخطر، أن تكون سُنَن النَّبي ﷺ في نَظر المسلمين تابعةً لعقولهم المُتنافرة، والخيرُ كلُّ الخير في أن يكون الدِّين بسُنَّةِ رسولِه ﷺ حاكمًا، والعقل مُفسِّرًا ومُبيِّنًا، مَخلوقًا ليَسير خلفَه لا ليُواجِهَه!
وإنِّي لأضمنُ لإخواني من أحباب رسول الله ﷺ، أنَّهم إن ساروا وراء سُنّته تفقُّهًا فيها على أصولِ مذاهب الأمَّة المعتبرة، ثمَّ أحسنوا تنزيلَها على واقِعهم بالحكمةِ وحُسنِ السِّياسة: أن يتمَّ لهم كلُّ شيء، ويبلغوا ما يُريدونه مِن الجامعتين الدِّينيَّة والسِّياسيَّة، كما تَمَّ لأسلافِهم في العهدِ الأوَّل.
والله الهادي إلى الحقِّ لا إله إلَّا هو.